ترجمة د. تحسين رزاق عزيز
الصبية الوحيدة ذات الاثني عشر عاما
لن أقوم بوصف كيف كانت تلك الصبية ذات الاثنتي عشرة سنة نظيفة في مظهرها الخارجي. فكما هو معروف، المظهر الخارجي يُنبئ عن الكثير، ولكن ليس عن كل شيء، يمكن للمظهر الخارجي، في سبيل المثال، أن يكشف كيف يأكل الشخص وكيف يمشي وكيف يتكلم وماذا يقول وكيف يُجيب عن سؤال المعلم أو كيف يجري في المتنزه، ولكنه لا يُنبئ مطلقاً في أي حال من الأحوال عن الكيفية التي تسير فيها الحياة الداخلية، وحتى لا يمكن لأحد أن يخمن ولا يستطيع الحكم على الشخص من خلال المظهر الخارجي الفارغ. فحتى لدى المجرم، على سبيل المثال، يجري حوار داخلي مستمر مع نفسه، حوار تبريري تسويغي، يا ليت أحدنا يسمع هذا الحوار، ليته فقط! وعند الصبية العادية البسيطة ابنة الاثني عشر عاماً جرى هذا الحوار باستمرار من دون انقطاع، فطوال الوقت كان عليها أن تقرر ما يجب القيام به في كل دقيقة تماماً – كيف وماذا تجيب، وأين تقف، وإلى أين تذهب، كيف تتصرف. وكل هذا من أجل هدف واحد مهم جدًّا، من أجل أن تخلّص نفسها، لكي لا يضربها أحد ولا يثيرها ولا يزاحمها.
القوة لدى الطفلة التي لا يتجاوز عمرها اثني عشر عامًا للتعامل مع طبيعتها العنيفة، ولا مراقبة نفسها ولا أن تكون مثالاً للسلوك الجيد والدقة والصمت القوة لا تكفي، والطفلة تعربد وتجري وتصرخ فتتمزق جواربها، وحذاؤها دائماً رطب من هذا الصخب في المتنزه الخريفى البليل، وفمها لا يُغلق، تنطلق الصرخات من قفصها الصدري لأنها تلعب لعبة المطاردة أو الشرطة واللصوص. وفي المدرسة أيضًا أثناء الفسحة طرادٌ في الممرات – الشعر، أشعث، والأنف يقطر، فإما العراك وإما الجمال.
إنَّ الطفل الذي يبقى من دون أمه، ويجب أن يقوم هو بالاعتناء بنفسه – على الأقل عليه أن لا يضيّع حاجياته، بدءاً من تلك الحاجيات التي يمكنه السير بها عبر الحديقة إلى المدرسة، لا أن تكون فردة من الجوارب موجودة، والثانية تبحث عنها في المهجع كله. أول شيء يختفي هو المناديل والقفاز (الأيمن) والوشاح، ويجري البحث طويلاً عن القبعة، ناهيك عن أقلام الرصاص والمسطرة والممحاة الضائعات دائماً. وأغلب الظن أنه لا يمكن العثور على أيّ من تلك الحاجيات عند أي أحد في الفصل.
وحتى إن الصبية فكرت بكتابة حكاية عن بلد الحاجيات الضائعة الذي تختفي فيه كل الأمشاط (نعم، فقدت حتى مشط الشعر)، والأشرطة من جدائلها، والدبابيس وقلم الحبر وأقلام الرصاص كلها، وهلم جراً. لا عودة لشيء من هذا البلد، هكذا وضعت الخطة التي ستكون عليها الحكاية.
وها هي الصبية التي أضاعت أشياءها الصغيرة كلها لا يمكن أن تعيش من دون قلم رصاص وممحاة ومسطرة ومن دون مشط وأشرطة ودبابيس الشعر، فكتبت لأمها رسالة: ماما العزيزة، كيف حالك، أنا أموري جيدة، أرسلي إليّ – وذكرت اللائحة بأكملها.
من رواية صبية من متروبول، ليودميلا بيتروشيفسكا
دار المدى، 2019، ص (131-132)
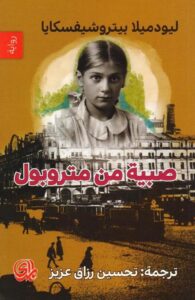
زوجة الجنرال غلاديشيف لحظة جنونها الفعلي
شيد الجنرال غلاديشيف الكثير من المشاريع العسكرية وشبه العسكرية في حياته، ونال الكثير من الأوسمة على صدره العريض والقصير إلى درجة أنه لم يَخَف من السلطات. ليس، بالطبع، بالمعنى الذي فيه لا يخاف الفيلسوف أو الفنان في بعض الدول البورجوازية المرفَّهَة من السلطات، ولكن بالمعنى الذي فيه بقي حياً في زمن ستالين من دون أن يفسد، وعاش في وئام مع خروتشوف الذي كان يعرفه من سنوات الحرب، وكان واثقًا أنه سيجد لغة مشتركة مع أي سلطات. لم يخشَ إلا زوجته فيرا إيفانوفنا. ووحدها فيرا إيفانوفنا، زوجته الوفية وصديقته المقاتلة، عكَّرت هدوءه ودمرت أعصابه. لقد اعتبرت رتبة زوجها العالية ومنصبه الرفيع وكأنهما ملكها الخاص، وكانت تعرف كيف تطالب بكل ما اعتقدت في ذهنها أنه من حصتها. وفي بعض الأحيان لا تحتشم وتتسبب في فضائح. وهذه الفضائح بالذات هي أكثر ما كان يخشاه بيتر ستيبانوفيتش. إذ كان صوت زوجته عاليًا جدًا، وقابلية السمع في الغرف العالية مرتفعة وعوازل الصوت غير كافية. وما إن تبدأ في الصراخ حتى يستسلم على الفور:
– اخجلي من الجيران، لقد فقدت عقلكِ.
بعد جوعها خلال طفولتها في مدينة فولوغدا وفقرها أيام شبابها، أصبحت فيرا إيفانوفنا مهووسة إلى الأبد بغنائم ألمانيا التي جلبها بيتر ستيبانوفيتش ملء عربة شحن واحدة في نهاية عام خمسة وأربعين، مع إنَّ بيتر ستيبانوفيتش رجل غير جشع لكنه كذلك غير بليد، ومنذ ذلك الحين لم تستطع فيرا إيفانوفنا أن تتوقف وظلت تشتري وتجمع السلع بكميات كبيرة.
عندما يوبِّخ زوجته ويشتمها بأنها مجنونة ومخبولة، لم يكن يعتبرها حقاً كذلك بالمعنى الحرفي للكلمة. لذلك، في تلك الليلة، بعد بضعة أشهر من وفاة ابنتهما عندما أيقظته غمغمة زوجته التي كانت تقف في ثوب نوم وردي فاتح أمام الدرج البارز لطاولة الكتابة النسائية التي جلبت على ما أتذكَّر من بوتسدام (في ألمانيا)، لم يخطر بباله مطلقًا أنه حان الوقت لإيداعها في مستشفى المجانين.
– إنها تعتقد أنها الآن ستحصل على كل شيء مني… ستحصل، القاتلة الصغيرة – كانت فيرا إيفانوفنا تلف في منشفة موبِرَةٍ مروحة يدوية صينية وبعض الزجاجات الصغيرة.
– ماذا تفعلين في منتصف الليل، أيتها الأم؟ – قال بيتر ستيبانوفيتش رافعاً نفسه على كوعه.
– ينبغي أن نخبئّها، يا بيتيا (بيتر)، أن نخبئها. إنه يعتقد أن ذلك سوف يمر ببساطة. – وتوسعت حدقات عينيها إلى درجة تداخلت فيها تقريباً مع الحافات السود للقزحية، وبدت عيناها ليس رماديتين بل سوداوين.
استشاط الجنرال غضباً إلى درجة أنَّ الحدس القبيح الذي يجول في صدره قد تحرَّك على الفور. فشتمها بعبارة طويلة من السباب البذيء، كأنه يقذفها بحذاء، وأخذ وسادة وبطانية وذهب ينام في غرفة المكتب، وهو يجر الشريط الطويل لسرواله الداخلي العسكري.
من رواية ميدييا وأبناؤها، لودميلا أوليتسكايا
دار المدى، 2020، ص (159-161)

النظر إلى جثمان رجل في تابوته
كان العمل يجري على قدم وساق في مقبرة نيكولسكويه. فقد كانت حفارتان آلیتان تزمجران في ضوء الكشافات القوية وتستخرجان التربة، كما بدا لي من القبور وتكدساتها في أماكن خالية. كلا، ليس من القبور. فعندما اقتربتُ أصبح واضحاً لي أن الآليتين كانتا تعملان على الممشى – تحفران خندقاً من طرفىّ الممشى المتقابلين. وفي الوقت نفسه، تراءت لي على الخندق التربة بلونها الأسود بالإضافة إلى عدة توابيت مرفوعة على السطح. إذ إنَّ صفوف القبور على مدى سنوات عديدة من وجودها لم تعد تبدو صفوفاً، وشغلَتْ بعض المدافن نصف الممشى تقريباً. من الواضح أنه كان من الضروري نبش هذه القبور.
تذكرت أن قبر تيرينتي أوسيبوفيتش ناتئ أيضاً، وخطرَتْ على بالي فكرة مفادها أنه لا مناص من تعرّض قبره للمضايقة من أجل شق الخندق الغامض. بعد أن مشيتُ على طول الخندق الممتد خلف الحفارة الثانية توقفتُ بشكل مناسب كالمغروس في المكان: كان تابوت تيرينتي أوسيبوفيتش مطروحًا بالفعل على كومة من التراب الطري. بالطبع، لم أكن متأكداً من أنَّ تبرينتي أوسيبوفيتش بالذات هو الذي يرقد في التابوت، لكن التابوت طُرِحَ فوق قبره مباشرة – فتابوت من سيكون إن لم يكن تابوته؟
اقتربت من التابوت حتى التصقت به. كان أحد الألواح الجانبية من التابوت ساقطاً لكن لم يدخل ضوء الكشاف في التجويف المتكون. ولم يكن ثمة شيء مرئي من خلاله. ومن دون فتح الغطاء، لا يمكن البت بأنَّ مَن في التابوت هو تيرينتي أو سيبوفيتش بالفعل. لكن، يا ترى كيف يمكن فعل ذلك؟
بينما كنتُ أفكر، مُدَّ أنبوب مرن من السيارة القادمة. سُحِبَ من لفافة عملاقة دارت فجأةً بصوت رفيع. فقد شُقَّت التوصيلات المائية عبر المقبرة – في الليل حتى لا تضايق أحدًا من الناس. وضع الأنبوب بعناية في أسفل الخندق. كان الجميع ينظرون كالمسحورين كيف أن سلطات المدينة، بعد أن وفرت المياه للمواطنين الأحياء باشرت بتجهيزها للمتوفين. ومن دون أن يلاحظني الآخرون قمتُ بخطوة نحو التابوت ووضعتُ يدي على خشبة الغطاء نصف التالفة، ولمستها. كانت ثمة فجوة صغيرة في المكان الذي يقترن به الغطاء مع التابوت. وضعتُ أصابعي فيها رفعتُ الغطاء بقوة إلى الأعلى.
لم تكن ثمة حاجة إلى بذل القوة: فقد رُفِعَ الغطاء بسهولة. ألقيتُ مرة أخرى نظرة على المحيطين بي – كان الجميع لا يزالون مشغولين بمراقبة وضع الأنابيب. رفعتُ الغطاء بحركة واحدة ودفعته إلى حافة التابوت. وبفضل شعاع الضوء الساقط من الأعلى أصبح جثمان الرجل مرئياً. هذا الرجل كان تيرينتي أوسيبوفيتش بالذات. فقد عرفته على الفور.
شعره الشائب ملتصق بالجمجمة السترة الرسمية لم يمسها التعفّن تقريباً. هكذا، في الواقع، كان خلال حياته. وفي الحقيقة، فقد اختفى الأنف، وثمة اثنان من الثقوب السوداء في مكان العينين، ولكن ما عدا ذلك بدا تيرينتي أو سيبو فيتش الميت يشبه نفسه. وللحظة انتظرته ليحثني على المشي من دون خوف، ولكن بعد ذلك لاحظت أنه لم يكن لديه فم أيضاً.
من رواية الطيار، يفغيني فودولازكين
دار المدى، 2020، ص (313-314).
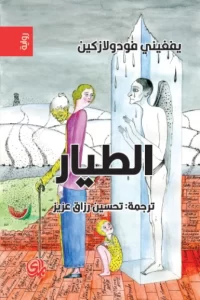
* عناوين الفقرات من وضع المحرر وليست جزءًا من النص المترجم



