عفيفة سميطي بعد اكتشاف حجم اللغة والايقاع.. لا مكان للتراجع
سماورد
سماورد تستضيف في هذا الحوار روائية، وصِف انتاجها الروائي في مواضع مختلفة ولأكثر من مرة بأنها أعمال “غير منعزلة عن إيقاع الحياة”، وأنها “تحمل صوت الرفض والاحتجاج”، وتقارب مواضيع شائكة “باقتدار فنيّ وبوعيٍ ثقافيّ”؛ هي الكاتبة التونسية عفيفة سعودي سميطي، التي صدر لها حتى الآن ثلاثة أعمال: “هبني أجنحة” (2009) و”صدأ التّيجان” (2011) و”غلالات بين أنامل غليظة” (2014)؛ حازت على جائزتين من الجوائز الأدبية (الكومار الذهبي): التنويه الخاص عن روايتها الأولى في الدورة الثالثة عشر، ولجنة التحكيم الخاص عن روايتها الثانية في الدورة الخامسة عشر.
سماورد: هل كانت الكتابة بالنسبة لعفيفة السميطي خيارًا أم حاجة؟
عفيفة: الحاجة شعور قهريّ نفسيّ، يسلّط ضغطاً على الذّهن، فيترجمها حسب معطياته إلى خيار معيّن دون غيره. برغم ما يحمله معنى الخيار من تمويه ينفي حضور الجبْر، إلّا أنّه يظلّ دائمًا في مفهومه السّيكولوجي العميق وليد الحاجة؛ وبالتّالي لا يمكننا التحدّث عن حضور أحدهما دون الآخر فهما متلازمان. لعلّ السّؤال يكون أصحّ لو طُرح بشكل آخر “هل الكتابة تندرج في هذا الحيّز الضيّق من الجبر والاختيار؟ أم انّها شأن أعقد بكثير من ذلك، يمضي إلى حدّ اعتبارها حاسّة سادسة، تتحرّك بمعزل عن الارادة وعن العالم المادّي الموضوعي، وتعبّر عن نفسها في لحظة الوعي المناسبة؟ أم أنها كانت حاضرة في موسم العلقة، فمن هناك تنشأ الكيمياء التي تقودك إلى مصيرك؟” لم أدرك، وانا أتقصّى السّرد حتّى أبلغ نهاية الحكاية بنهم غريب، أنّي كنتُ أسيرة هرمون يفرزه عقلي لا يكتفي بالسمع فقط، ولكن يُخزّن في كلّ حكايةٍ وحدثٍ كمّا هائلًا من التّفاعلات الكيميائيّة النّاتجة عن التّأثّرات، تلك التّأثّرات كانت تُؤشّر لمناخ لا يجول في مداري؛ فالكتابة كانت شأنًا محفوفًا بالقدسيّة، وظللْتُ أفعل ذلك بعيدًا عن حلقة الرّوائيين، في محاولات أقبرها بين الأدراج. لا أزال أحتفظ برواية كتبتها في سنّ صغيرة، وأطلقت عليها عنوان “الصّراع”. كان يمكن آنذاك أن تخرج للنّور، لكنّها ظلّت في كيس أسود مع صور قديمة. في لحظة فارقة، وجدّ متأخّرة، تكثّفت داخلي رغبة في التّجربة؛ مجرّد سؤال طرحته على نفسي وضعني أمامها “هؤلاء الذين كتبوا، ماذا فعلوا عدا الحكي؟”، وكان الحكي داخلي لا ينتظر سوى إجابتي، ولم تمرّ سنة حتّى أنهيت روايتي “هبني أجنحة”. اكتشفت حجم اللغة التي تسكنني، وحجم الإيقاع الذي أوقعني في دوزنتها. وجدت نفسي، وبعد أن نالت روايتي الجائزة التقديرية لكومار، وجهًا لوجه مع أحد الذين كتبوا النّصوص الأولى، وقرأنا له ونحن في مقاعد الدراسة، بدا لي الأمر خطوة شاهقة. عندما أعدْت التجربة، كانت رواية “صدأ التّيجان”؛ وهي تحصل على جائزة لجنة التّحكيم لكومار؛ تشير إلى الماضي المقبور. بين صفحاتها، كانت الرّؤى المدفونة تنفض عن رفاتها وهم القدسيّة. آنذاك، أفصحت “غلالات بين أنامل غليظة” عن وجهها، ولم يعد هناك مجال للتّراجع. الآن؛ فقط الآن، لم يعد الحكي هو المحور. أنا عالقة في الراوية الرابعة، ومنذ أربع سنوات.
سماورد: تناول الراحل الدكتور محمد الباردي، في كتابه “تأملات في الرواية التونسية”، مسألة الرواية التي تكتبها المرأة في تونس، أشار إلى أن هناك اتجاه للرواية النسوية وهو اتجاه إيديولوجي في الأساس ويمثله آمال مختار وعفيفة سعودي السميطي. هل تتفقين مع التصنيف الجنساني للكاتب/ـة حين تناول العمل الروائي؟
عفيفة: يحيلني هذا السّؤال إلى استراتيجيّة التّفاصيل، حيث تعلن المرأة عن نفسها بتقنياتها الخاصّة في عملها الإبداعي، فتمضي إلى المساحات المغلقة والتي عجز الرّجل عن الولوج إليها، وتفتحها بمرونتها الواسعة بعيدًا عن الصّرامة. تفعل ذلك كما في الواقع، مكتسبة الحكمة من تكوينها المذهل، حيث تتناسل فيها الحياة، وتمنحها الأمومة طاقة الوجدان فتعبّر عن الحبّ بصدق صرف يضع الرّجل أمام إشكال القصور؛ فيمعن في الإعلان عن ذكورته لا عنفًا ولكن انبهارًا واحتياجًا وخوفًا من غيابها. هذا الهلع يحيلني الى مأساة “بجماليون” الذي وقع في بؤرة العذاب لإدراكه أنّ “جالاتيا” لن تكون كاملة، وعاش الشّقاء؛ لأنّه ارتاب، والكمال المفقود الذي ارتآه ذريعة تأسرها للأبد في خانة الفضيلة انهار، ولم يفلح في استبقائها. “أفروديت” الرّبّة كانت أنثى، ولم تضخّ في التّمثال سوى إكسيرها الصّاهر المتمرّد؛ ففجّرت الحياة فيه، وثوّرته محطّمة بذلك الأنا الطّاغية الكامنة فيه، لتذكّره أنّ الكمال ليس سوى وجه آخر للموت. فهل في توقها لوجود حرّ استلبه منها تكون شبيهة له في تقنياته؟ وهل في إعادة تشكيلها لنموذجها ستستعمل تصاميمه مهما كانت بالغة الجمال؟ سيغدو الأمر تقليدًا، وهي تستعمل أزاميله ومطارقه والأدوات الحادّة لتعلن عن قوّة لا تحتاجها. بعضهم، ومن منظور المساواة، يرى أن خانة الأدب لا تعترف بالجنسانيّة، إلّا انّ اللّغة تظلّ دائمًا المترجم الدّقيق للكيمياء البشريّة، وإذا باتت الكيمياء واحدة فمعنى ذلك أنّ أحدهم انصهر وذاب.
سماورد: ماذا عن التوصيف بأن عفيفة تحصر الكتابة في إشكالية الذكورة والانوثة؟ ’’عندما يتحدث الكاتب عن التّفاصيل فالأمر يصبح عاطفيًّا حميميًّا؛ فهي سبيله إلى الارتقاء بالقارئ إلى مصافّ الصّداقة’’
عفيفة: حَصْرُ الكتابة في إشكاليّة الذّكورة والأنوثة يعني القصور. عناوين رواياتي، وعتباتها، ومضامينها مضت إلى أبعد من ذلك. فإزاء واقع عربيّ مهترئ أنهكته الدّيكتاتوريات والفتن والفقر والبطالة والهزائم، كان ولا بدّ، وأنا ألج عالم الكتابة، أن أعي خطورة الرّسالة، وأعبّر عن واقعي بوجهة نظر ثوريّة، “هبني أجنحة” كانت صرخة انطلقت من رحم الانسحاق والكبت “إلى من حاول العبور عبر مركب وقلم، يرجو الطّفو فوق لجج تغتال الرّفض فتصيبه بالخرس، إلّا أنّه ينتفض حتّى لا يموت صامتًا”، كانت حلمًا حارقًا جسّدْتُه في مسيرة تعيد الذاكرة إلى سنوات الاحتجاج في السبعينات والثمانينات، عندما كان الشّعوب العربيّة تمارس فعل التّظاهر تحت توجّهات فكريّة مختلفة: حلمها الوحدة العربيّة، وإسقاط الأنظمة المستبدّة، وإرساء الدّيمقراطيّة والحرّيّات. بدت الفكرة موغلة في الغربة في سنة الفين وثمانية، بل مضحكة ومحزنة؛ ففي ذاك التّوقيت كانت الشّعوب العربيّة تمارس نمطًا من الحياة يشبه لحدّ بعيد نمط القطيع الذي يسير كلّ يوم في نفس الطّريق ليعود عبرها في المساء، مُغيّبَا عن الوعي، أجراس الكلاب حوله تذكّره بالحفاظ على المسار، بينما الرّعاة تطلّ عليه من شرفات القصور. كنّا من خلف الشّاشات نتابع قصف الاوطان وتغوّل الحكّام والملوك والخيانات، ولا نملك سوى الأنين الصّامت، الكتابات الثّوريّة غارت مع أصحابها في السّجون، وسربل السّكون واقعنا المأساويّ؛ لكن رغم ذلك، واتتني الجرأة وأعلنتُ التّمرّد مثوٌرة الواقع بفتح الجروح ونكئها، فكتبْت عن قوارب الموت والهجرة السّرّيّة وسجناء الرٌأي والقلم والقمع، ولم تنل مسألة الذّكورة والأنوثة سوى النٌزر القليل من كتابتي. “صدأ التٌيجان” كانت الصّرخة الثّانية، عتبتها أعلنت عن سرب سيحلّق كاسرًا كلّ القيود حاملًا في مناقيره التّيجان الصّدئة وإلى جمار الشّمس سيلقيها. رواية سياسيّة شرّحتُ فيها عنف الملوكيّة ملوّحة بحلم عسير التّحقيق، ثوّرت فيه شخصيّاتها وتركتهم يغيّرون الواقع بآلياتهم. لم أكن اتصوّر، وأنا أخوض تلك الملحمة مع شخصيّاتي، أنّ الأمر وشيك الحدوث. كانت سنة الفين وعشرة تلفظ أنفاسها، ولم يلبث العام الجديد أن أعلن عن وجهه الحانق، وأشتعل سعير الثّورات في أوطاننا، وشهدنا بذهول سقوط أنظمتنا التي خلناها لطول ما حكمت أزليّة. روايتي “صدأ التّيجان” كانت سياسيّة بامتياز. تلتها “غلالات بين أنامل غليظة”، والتي كانت الوجه الآخر للثورة: “إلى رجل خاض حربًا ظنّها حربه المنشودة ثمٌ أدرك فجأة أنّها الحرب الخطأ، وخاض أخرى أشدّ منها ضراوة ليبرأ من جلْد الخطأ”، كان الإرهاب قد شرع في تمزيق الأوطان بضراوة وكيّها بناره المستعرة، وبدا لي أنّ كلّ تلك الحرّيّة المطلقة لن تكون سفينة النّجاة، بل الوعي بإعادة النّظر في المكبوت والمقدّس هو الحرب القادمة التي ستشنّها الكتابة. رواياتي اتّسع مداها ولم تقف عند الحدود.
سماورد: الروائيّ حين اشتغاله بعمله قد يعود بوعي، أو بدونه، إلى مخزونه من تجارب حياتية شخصية، أو قراءات ومطالعات، أو خبرات موروثة من الزمان والمكان. وربما إلى موارد أخرى. كيف هو الأمر بالنسبة لعفيفة؟
عفيفة: نلجأ للرّواية لنخلق عالمًا لا تطؤها تجاربنا الشّخصيّة، إذ الأمر برمّته كسْرٌ وثورة على نمطنا الخاوي من السّحر، قد يأخذ  الأمر وقتًا طويلًا حتّى نُدرك أنّ الحكي ضفّة لا تُدركُ، لكنّها تُرغمنا على الإبحار لِنحرّك أشرعتنا ولنوقظ بوصلاتنا الميّتة فنواجه بذلك تيّارات قد تُغرقنا، غير أنها في حال فشلها تمنحنا عالمنا الجديد الباهر. الخيال، ذاك الكائن المدهش، الواقف على براكين سابقة للبشريّة، بغريزته الصّارخة أكان سيتعرّق بمجرّد اجترار موروثات غدت في عرف الزّمن آثارًا للفرجة ونوافذ لعالم قديم؟ يبدو ذلك ساذجًا، بل مهينًا، حتّى أنّ ركود البشريّة وموتها يبدآن عندما تسجن نفسها داخل تلك التّرّهات البائسة. ما نتحدّث عنه استثنائيّ في خصائصه، عاصف، حارق، لذيذ وقويّ، يقصف بالهدوء، يشبه لحدّ بعيد طبيعة جوف الارض، فاتن عندما يتعلٌق الأمر بالجيولوجيا، خصب عندما تُفصح المعادن الثّمينة عن وجوهها البرّاقة، متفجّر عندما تعلن البراكين عن نيرانها المدفونة، لا يحتاج سوى لغة تُشبهه ُيفصح بها عن وجوده الخلاّق. القراءات والمطالعات قد تمنحنا سبيلًا للغة، لكنّها لن توصلنا إليه؛ حضوره داخلنا يشبه لحدّ بعيد حضور الموسيقى، يطرب العالم وينتشي كلّما غَنّيْنا.
الأمر وقتًا طويلًا حتّى نُدرك أنّ الحكي ضفّة لا تُدركُ، لكنّها تُرغمنا على الإبحار لِنحرّك أشرعتنا ولنوقظ بوصلاتنا الميّتة فنواجه بذلك تيّارات قد تُغرقنا، غير أنها في حال فشلها تمنحنا عالمنا الجديد الباهر. الخيال، ذاك الكائن المدهش، الواقف على براكين سابقة للبشريّة، بغريزته الصّارخة أكان سيتعرّق بمجرّد اجترار موروثات غدت في عرف الزّمن آثارًا للفرجة ونوافذ لعالم قديم؟ يبدو ذلك ساذجًا، بل مهينًا، حتّى أنّ ركود البشريّة وموتها يبدآن عندما تسجن نفسها داخل تلك التّرّهات البائسة. ما نتحدّث عنه استثنائيّ في خصائصه، عاصف، حارق، لذيذ وقويّ، يقصف بالهدوء، يشبه لحدّ بعيد طبيعة جوف الارض، فاتن عندما يتعلٌق الأمر بالجيولوجيا، خصب عندما تُفصح المعادن الثّمينة عن وجوهها البرّاقة، متفجّر عندما تعلن البراكين عن نيرانها المدفونة، لا يحتاج سوى لغة تُشبهه ُيفصح بها عن وجوده الخلاّق. القراءات والمطالعات قد تمنحنا سبيلًا للغة، لكنّها لن توصلنا إليه؛ حضوره داخلنا يشبه لحدّ بعيد حضور الموسيقى، يطرب العالم وينتشي كلّما غَنّيْنا.
سماورد: في شهادة لك عن روايتك الثانية “صدأ التيجان” خلال ندوة “انشائية التفاصيل في الرواية العربية”، التي عقدت في أبريل العام 2017 م، ذكرت: “أنّ فنّ التّفاصيل يحتاج إلى استراتيجيات وخطط”. ماهي استراتيجيات عفيفة السميطي وخططها في ذلك؟
عفيفة: عندما يتحدث الكاتب عن التّفاصيل فالأمر يصبح عاطفيًّا حميميًّا؛ فالتّفاصيل هي سبيله إلى الارتقاء بالقارئ إلى مصافّ الصّداقة بها. يرصد الكاتب تقنيًّا هذه العلاقة، وبالتّفاصيل يُشبع فضوله ويُغريه بالبقاء والمتابعة والاستمرار في القراءة. بالتّفاصيل يُحفّز حواسه ويُخاطبها، يضع له علامات تجعله يسمع ويشعر ويرى بقوة الكلمة المكتوبة، بها يفرض عليه عالمه التّخييلي مدركًا عميق الإدراك أنّ هذه الصّداقة لن تتحقق بالطّرق المباشرة ولا بالتّقنيات المفضوحة، لكن تتشكّل كلّما تحصّن بتقنيّات الكتابة الروائيّة وبجماليتها. التّفاصيل هي الطّْعم الذي يرميه الكاتب ليعْلق به القارئ، وكلّما كان جيّدًا في استخدامها كلّما نجح في إقناعه بأن يظلّ عالقًا بالنّص؛ فالغاية هي الإقناع والإبْهار. “انظر إلى هذه الأسراب إنها تْحدث شكلًا في السّماء رغم ضآلة أجسادها.” هي الجملة الأولى في روايتي “صدأ التّيجان”. طعْمٌ أُلْقيه للقارئ لأُغريه بالنّظر إلى شكل يُحلّق في السماء؛ شكلٌ هو في حدّ ذاته تَشَكَّلَ من أجزاء صغيرة تجّمعت في الْتحام متين لِتُكَوِّنَ السـّرب أو الأسراب. كلّنا يعلم أنّ قطعة “البازل” المُكَوّنَةُ للسّرب ما هي في الواقع إلاّ عصفور ضئيل ضعيف لا يُرى. استعملتُ التّشكيل عن طريق التّجميع لأُلْفِتَ نظر القارئ إلى أنّ هذه اللوحة المحلّقة في السماء جِدُّ محمّلة بالرموز والمعاني، وأنــّها لا تَحلّق جزافًا. أُغريه، وأفتح شّهيته، وأدعوه للتمعّن في العلاقة الكامنة بين العتبات؛ بين العنوان “صدأ التيجان” وبين الإهداء: “إلى من حوّل الأطفال إلى سرب يطير، يحمل في مناقيره تيجانًا صدئة وإلى مواقد الشمس يُلقيها، لا السّرب أثناء حملها يقع، ولا السّرب بعد رميها يحيد”. فكرة الحرية والثورة، وانعتاق الجسد الضّئيل، والأسير جسّمتُها في لوحة، تمامًا كما يفعل الرسّام: طيور ضئيلة، ضعيفة تتجمع لتُحدث هذا الشّكل الكبير المتمثل في السّرب، وتُحقّقّ له القوة بِاتّحادها والقدرة على التّحليق لمسافات طويلة في هجرة كبيرة إلى المدن الدافئة والخصبة. في تَحصُّني بهذه اللّوحة، كنتُ أنشد جماليّة الوصف؛ لأوقع بالقارئ في حبائل إغرائي ولأقنعه بعالمي التّخييلي. طبعًا، الأمر لن يتوقّف عند لوحة واحدة بل سيتواصل في روايتي “صدأ التّيجان”، وستتنوّع التّفاصيل حتى تُصبح اللّوحات مُجَمَّعَةً معًا، بانورما تُنْبِئُ بالصّور المتتالية عن نصّ يزخر بالأماكن والأزمنة والأحداث. التّفاصيل عندي هي فنّ الإقناع: “حسرت عن صدرها الأعجف وأخرجت ثديا جافـّا، شرع الطفل يمتصّه دون أن ينقطع أنينه وضربه لصدر أمّه”. جَسِّمْتُ جدليّة العلاقة بين الجسد والأرض، بين الخصوبة والجفاف، بين العبوديّة والحرّيّة، بين الشّمال والجنوب، بين المثقّف والجاهل، بين المُتَنَاسَي والمُتَجَاهل، والمُعتني به بهذا الثّدي النّاشف الذي يُجسّم خصوبة الأمومة في ظّلِ جسد مُضْطَهَد محروم؛ لا يتّوقف عن تأدية وظيفته الطبيعيّة رغم قسوة المناخ، ومرارة التجاهل وضنك الحياة. صورة الطّفل المُعلّق إلى ثدْي ناشف، هي الصّورة نفسها، تنطبق على صورة الفلاّحين المُعلّقين إلى أرض قاحلة لا يتوقّفون عن حبّها والاعتناء بها رغم جَدْبِهَا في إصرار كبير على الانتماء. “لعلك تكون الملك الفاضل.” لن أكون كذلك؛ لأّن البروتوكول هو الذي صنعني، أنا التمثال الذي تَشَكّلَ فهل حدث مرة أن حاد التّمثال عن رؤية نحاته؟ هل حدث مرّة أن رفع التمثال يده، وصفع النّحّات لأنّه رفض الشّكل الذي اختاره له؟ هل حدث مرّة أن بكى التّمثال؛ لأنّ النّحّات جَمَّدَ فيه رغبة ظلّت لدهر طويل عالقة بجسده؟ هل حدث مرة أن تمرّد التّمثال وانتفض مبعثرًا عبوديّته للشّكل؟ لا يتغير التمثال إلاّ عندما يقع ويتحطّم وتتناثر شظاياه، آنذاك يتخلّص من تَكَلُّس الفكرة على جسده ويتحرّر من نعته صنما”. اخترت في هذه الصورة “التمثال” للتّعبيّر عن العبوديّة، فهذا الشّكل المنحوت والذي لم يختر جزئياته، لا يستعيد حرّيته إلا عندما يقع ويتحطّم، ويتخلّص من تَكَلُس الفكرة على جسده، جزئياته يمكن أن تدبّ فيها الحياة وتختار لنفسها شكلًا آخر متحرّكًا يُجَسِّم به حرّيته. نلاحظ هنا الفرق بين صورة السّرب الذي يستمدّ الحياة من تَجَمُّعِ جزئياته واتّحادها وينطلق مُحَلِّقًا حُرًا قويًا، وبين التمثال المُشكّل والذي ينبغي أن يتحطّم إلى جزئيات حتى يستعيد الشكّل المناسب لحرّيته. فكرة توريث الحكم والتّداول على السّلطة، والعلاقة العموديّة التي فرضها صُنَاعُ السّياسة على شعوبهم اسْتعرْتُ لها صورة النّحّات والتمثال، وكلّ الأدوات الحادّة الماثلة خلف المشهد، فما من نحت دون مطرقة وإزميل ومبرد تمضي في جسد الصّخر لتُشكّله، ونفس الأدوات تستعملها الأنظمة الدّيكتاتوريّة لحفر الطّاعة على أجساد شعوبهم سواء بالممارسة الفعليّة أو بالممارسة المعنويّة. خلاصة القول، التّفاصيل بالنسبة للكاتب هي مشروعه الذي يرمي إلى قراءة جديدة يتولّد منها فهم جديد للعناصر البلاغيّة المُشكّلة لخطابه، والمُتّصلة بالأسلوبيّة بمعناها الوظّيفي. هي فَنُّهُ الذي يخلق لدى القرّاء خبرة تجعله يفهم. هي جدارته في استعمال عدسته الدّقيقة للاقتراب منها أكثر لإظهار جُزئيّاتها الصّغيرة، والتي تشبه جزئيات الفسيفساء وحصى الصحراء، والقدرة على جمعها وإجادة ترتيبها لتكتمل المشاهد والصّور، ولتخلق تلك الدهشة بمدى التوظيف والبراعة. رواية “صدأ التيجان” مليئة بالتّفاصيل ولعلّ التّفاصيل أسهمت إلى حدِّ كبير في بنائها. والنّساء في كتاباتهّن يمضين أكثر إلى التّفاصيل بِحكم طبيعتهن التّوّاقة إلى الجمال والوصف والإسهاب، لذلك فضاءاتهّن تزخر أكثر من الرجل بالجُزئيات والفسيفساء والتّشكيل.
سماورد: جمعية مركز بيت الرواية بقابس، ماذا يعني انتساب الكاتب/ـة لمثل هذه الجمعية التي تختص بالعمل الروائي؟
عفيفة: جمعية مركز الرّواية بقابس قطب كبير امتدّ إشعاعه حتّى خارج حدود الوطن. أسّس لحضور ثقافي في الجهة، وجمّع حوله روّاد الفكر، استقطب أدباء من كافّة الدّول العربيّة أثْروْا بحضورهم ومؤلّفاتهم السّاحة الأدبيّة، رائده ومؤسّسه الكاتب والأكاديميّ محمّد الباردي الذي غادرنا مبكّرًا تاركًا فراغًا شاغرًا. لم أكن أنتمي لحلقة الأدباء، فقد كنتُ ككلٌ امرأة أقدح قريحتي للحياة اليوميّة، “هبني أجنحة”، روايتي البكر كانت ذاك الكائن الحاضر داخلي، والمغيّب بفعل انشغالاتي العاطفيّة الملحّة، محتجزًا. ظلّت أجنحته المحتجزة دائبةَ الحركة، صوتُه ارتفع ذات صيف في وهدة غياب موحش وطفا على سطح أعماقي، عاليًا متوتّرًا، التقطتْه. في تلك اللّحظة ولم تلبث اللّغة أن حضرت بأساطيلها لتعلن أنّ هناك حكايات تحت الأنقاض وأنّ لا سبيل لانتشالها إلّا بأدوات تلك المَلكة المخمليّة السّاحرة. نالت روايتي حظّها، وأعلنت عنّي عندما تحصّلت على الجائزة التقديريّة. كنتُ مجهولة، بل بعضهم استغرب حصولي على جائزة من أوّل مرّة، فلم يكن لي تاريخ في الكتابة. احتفى بي مركز الرواية العربيّة وقدّم قراءات لروايتي مكّنتني من التعرّف على ادباء وشعراء الجهة، وأصبحت عضوة فيه. عادة الجمعيّات تحتاج الدّعم المادّي حتّى تنجز ندواتها المقترحة، هذا الدّور كان يقوم به الباردي ومساعده، ولا يتعدّى الأمر ندوة في السّنة، كان الأمر ناجحًا قبل الثّورة، ثمّ تقلّص الفعل الثّقافي بعدها، شأنه شأن كلّ المجالات، وساء الأمر أكثر بوفاته، وبات الأمر باهتًا.
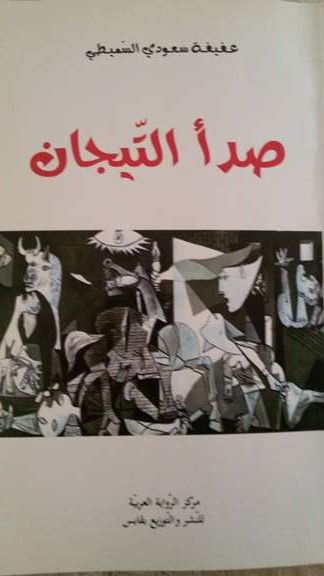
سماورد: إلى جانب الرواية، لك اشتغالات قصصية، كيف تنظرين إليها، مع ما يتردد أحياناً من أن القصة القصيرة ما هي إلا عتبات يتدرجها الكاتب للوصول إلى بوابة الرواية؟
عادة، وعندما نفرغ من رواية، ونستنفذ شعور الفرح بإنجازها نشعر بفراغ العاطل. ولأنّنا لسنا جاهزين لخوض أخرى؛ فإنّنا نظلّ لفترة قد تطول نناوش الكتابة دون التّورّط في نصّ روائيّ قد يبوء بالفشل. كتبْتُ نصوصًا كثيرة في تلك التّواقيت، كان الأمر ممتعًا حيث أنّها لم تتطلّب منّي حضورًا ثقيلًا كالذي تتطلّبه الرواية، كما أنّها ساعدتني على الخروج من سقف العنوان الواحد إلى سقوف العناوين المتعدّدة وبالتّالي تخفّفتُ وتحرّرت وطرقُت مواضيع متنوّعة، واستمتعتُ؛ فقد كانت عبارة عن استفراغ لذاكرتي المكتظّة وتنفيس لها باسترجاع الذّكريات وصوغها من جديد نصوصًا تخاطب ذاكرة الآخرين، وتفتح جسورًا بيني وبينهم. وجد ذلك صدىً، خاصّة عند القارئ الفايسبوكي. حكاية قصيرة تُمتع ذهنه؛ فلم تعد الرواية بحجمها الكبير تستقطب النّاس، وقرّاؤها أضحوْا قلّة، لذلك تماهيْتُ في تلك النّصوص، وفاق عددها الخمسين نصًّا. قصرها وسرعة قراءتها والتي تتمّ بفضل الفضاء الأزرق منحني شعورًا جيّدًا.
سماورد: هل هناك رغبة في ضمها في مجموعة تنشر؟
عفيفة: لا أدري إن كان طبْعها سيضيف لي شيئًا، لم أفكٌر في ذلك، هي فقط مراوحة واستراحة ومغازلة لمشروع رواية قادمة، أستكشف بها قدراتي وأتحسّس عوالم أخرى كانت خافية عني قد تكون في ثناياها عتبات لنصوص طويلة، لا أدرى فالكتابة حفر، والحفر دائمًا يكشف لنا أكثر ممّا نتوقّع.


